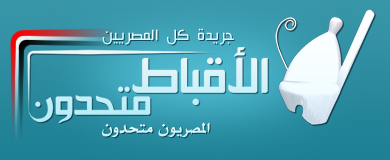نسبية اينشتاين وإخوان التخلف
بقلم: عزت بولس
أتاحت عبقرية العالم اليهودي "ألبرت اينشتاين" الفرص لكُتاب قصص الخيال العلمي أن يصولوا ويجولوا ،ومن ثم يصلوا للإبداع فيما يمكننا أن نسميه بالأدب الخيالي الذي يقوم في واحدة من أهم أساسياته على الترحال في الفضاء وعبر الزمن بارتكاز واضح على ظاهرة" التمدد الزمني" بنظرية اينشتاين النسبية.
التطورات الحالية لشكل الأحداث في مصر،خاصة بعد جمعة " غزوة الميدان" من أصحاب اللحى الطويلة والجلاليب القصير والشعارات التي ترن بالأذن منُذره للسامعين بحجم البؤس الفكري لأصحابها-منها كلنا أسامة بن لادن ،يا مشير يا مشير أنت الأمير،يا مشير يا مشير جيش محمد بالتحرير- كل ذلك أنشا بداخلي رغبة عارمة لرؤية مصر بعد ثلاثين عامًا من الآن وقادني تفكير الخيال العلمي – بعد أن أطلقت له العنان- إلى ابتكار مركبة زمنية تنقلني عبر الزمن لرؤية مصر المستقبل،وبالفعل بدأت في التحرك بآلتي مستعينًا بخبرتي في التعامل مع مركبات القيادة.
بدأت الرحلة وكان على اتخاذ قرار بأي الأماكن سأتوجه أولاً وبالفعل قررت أن أذهب لأكثر الأماكن التي أعشق التواجد فيها بأجازاتي القصيرة" أحد شواطيء البحر الأحمر" وعندما هبطت مركبتي الزمنية لم أصدق ما رأيت وبدأت بـ" فرك عيني" وذلك لأنني لم أكن متخيلًا أو قادر على تصديق ما رأيت،حيث اختفت الصورة الحضارية التي كنت أعيشها بتلك الشواطيء وغابت أجواء المرح المصرية والوجوه المبتسمة لشباب يعج بالحياة،ليحل مكان كل ذلك – الذي أصبح ماضي بعيد- أجناس لسائحين قادمين من بلاد الدساتير الدينية قسموا الشواطيء لجزئيين الأول للحريم المُنتقبات والأطفال دون سن السادسة،والجزء الثاني للرجال حيث يمرحون بجلاليبهم البيضاء بين أمواج البحر.
اللغة التي وجدتها سائدة كانت "العربية" واختفت تقريبًا باقي اللغات الحية الأخرى وإن كنت أسمع من بين الحين للأخر كلمات" فارسية" إلا أن ما أثار بصري كيف تحولت الشواطئ إلى موائد عليها ما تشتهيه أنفس مريديها،وكيف ساهمت تلك الموائد في إغراق رمال الشواطيء الجميلة بفضلات الطعام وأكياس البلاستيك السوداء المخصصة لجمع القمامة.
وجدت على الشواطيء أيضًا دوريات لرجال يُطلقون على أنفسهم حماة"الفضيلة والأخلاق" وكانوا يرتدون أحزمة تُستخدم لردع كل من تسول له نفسه أن يخرج عن"قيمهم الضابطة" التي هى مستمدة من تفسيرات دينية كانت توصف من قبل ثلاثون عام بالمُتشددة.
إلى هذا الحد اتخذت قرار سريع بمغادرة شواطئ مصر الشرقية، ووجهت بصله مركبتي الزمنية لزيارة أماكن أخرى كانت تعنى الكثير بالنسبة لي من مصرنا الحضارية الجميلة، ولكن انطباعي من حجم مشاهدتي السلبية لم يختلف كثيرًا عما رأيته على شواطئنا الطويلة، لكن الذي هالني هو اختفاء التماثيل -للشخصيات التي صنعت تاريخ مصر الحديث أو غيرها كتمثال نهضة مصر- من شوارع القاهرة، مما جعلني أذهب مسرعًا للمتحف المصري لأجده مغلق وبسؤالي عن السبب لهذا الإغلاق من بعض الغيورين على حضارتنا المصرية العريقة،جاءت إجابتهم مقتضبة حزينة إلا أنها مؤكدة على أن المسئولين أهملوا العناية بـ"الموميات" ففسدت بعد أن ظلت لسنوات محتفظة بما يكسبها الصلابة أمام عوامل الزمن والتحلل- وقد كانت ذات يوم من دواعي فخرنا وتأكيد على تفوقنا الطبي أمام العالم أجمع- المثير للاشمئزاز أن الحديقة التي كانت حول المتحف تحولت لمكان مهمل مليء بالقمامة ومأوي لمن يفتقدوا لوجود سقف ينامون تحته.
ولحجم شعوري بالأسى والحزن قررت العزوف عن مواصلة الذهاب لأماكن أجدادنا الأثرية كأهرامات الجيزة أو الكرنك بالأقصر،بعد أن وجدت منطقة سقارة الأثرية بلا أثار عدا قمة هرم زوسر ليختفي الذي كان يومًا ما تحت الرمال.
حولت دفة قيادة مركبتي الفضائية مُتجهًا لشوارع القاهرة متجولًا فيها، ليزداد حجم شعوري بالإحباط حيث لم ألمس أي تحسن ملحوظ في مستوى معيشة الإنسان المصري، بل شعرت بالهلع من حجم الزيادة في البؤر العشوائية، إضافة لاكتظاظ الميادين الكبرى بأطفال الشوارع المُتلفين حول السيارات في محاولة منهم لاستجداء الفتات من سادة القوم الجدد بمصر مُرتادي العقالات العربية،لكنني أيضًا لم أري مصريات بالشارع إلا فيما ندر وعندما سألت عن سر اختفاء المرأة؟ قالوا لي أن النساء لم يعد لهم مكان سوى المنازل حيث رعاية الأطفال،وذلك ليس قهرًا لهم لأنهم – أي النساء- خُلقن لأغراض منزلية وليس للمشاركة في العمل، وحتى عندما يخرجن للضرورة القصوى يختفين تحت نقاب أسود اللون.
في أخر محطات رحلتي الزمنية توجهت لزيارة بعض الكنائس بمنطقة "مصر القديمة" فوجدتها في حالة يرثى لها من حيث حالتها المعمارية التي تُركت بلا عناية حتى أصبحت أيله للسقوط وذلك لصعوبة لا بل استحالة الحصول على رخص لترميمها، لكن الإنسان داخل تلك الكنائس لم يكن أفضل حالاً من المباني حيث علامات اليأس مرتسمة على وجوه جموع المصليين، والذين كانوا يرددون الألحان القبطية بأصوات منكسرة مُنخفضة حيث منعت عنهم السلطات أجهزه المكبرات الصوتية.
وبنهاية رحلتي طلبت من ربى أن لا أعيش تلك السنوات حتى لأرى مقدار التدني الحضاري، الذي قد تصل إليه مصر إذا حكمها حفنة"الوهابيين"المستوردين والمُدعمين من السعودية.
غريزة "حب المعرفة"دفعتني للبحث عن الأسباب التي أدت إلى تأخر البلاد واحتلالها الفكري لصالح الوهابية التي بترت الهوية المصرية، وأدرت عجلة آلتي الزمنية عكس عقارب الساعة متجها إلى قاهرة أواخر ثلاثينات القرن الماضي، فانشرح صدري عندما لامست مدى الانفتاح والتعدد الثقافي في القاهرة، حيث كانت بوتقة جامعة التقت في رحابها تجارب وخبرات العديد من الحضارات الإنسانية، ولم ألاحظ أي نوع من الاحتقان الطائفي، حيث تعايش المسلم و اليهودي والقبطي في وئام وسلام تام.
بحثت عن سبب التعصب وكيف بدء وما هي بؤرته ؟ فوصلت بعد بحث إلى منبع الداء، حيث نجحت سياسة "الإنجليز" الثعلبية في بث الفتنة وزرعها بين أبناء الوطن بتبرعهم ب 500 جنية مصري لمدرس قادم من مدينة الإسماعيلية، كُلف بإنشاء "جماعه" دفعتنا بخطوات ثابتة إلى ما نحن فيه الآن من تدنى حضاري وجاهلية فكرية.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :