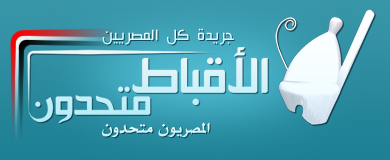مواجهة الظلم والفساد التزام وطني وإنساني من أجل كل المصريين!
بقلم / نبيل عبد الملك *
لا أعرف تماما معنى وسياق ما جاء على لسان البابا شنودة مؤخرا، أي رفضه لإصرار الأقباط، داخل مصر وخارجها، على إجراء تحقيق قانوني محايد ودولي فى كل الجرائم التي تعرض لها أقباط مصر، وتحديدا منذ مذبحة الزاوية الحمراء، فى يونيو 1981، وحتى مذبحة ماسبيرو، التي حدثت فى التاسع من أكتوبر من العام الحالي، وبينهما مذابح أخرى لن تُنسى، وممارسة التمييز الصارخ والضغط المتواصل عليهم بحملات من الحض على كراهيتهم وترويعهم بوسائل دنيئة رسمية وغير رسمية وصارخة.
الموضوع من أساسه قانوني، ويتعلق بحقوق الأقباط المصريين فى الحياة الآمنة والتمتع بحقوقهم الإنسانية كمواطنين؛ وهي حقوق لا يمكن التنازل عنها،
وليس لأحد أن يمنع الأقباط، أفرادا أو جماعة، من المطالبة بها بكل الوسائل المشروعة محليا ودوليا.
ومعروف في عالم اليوم، وهو أمر مشروع أيضا، أن في حالة فشل الدول والحكومات فى الوفاء بواجباتها والتزاماتها تجاه احترام حقوق مواطنيها، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق العدالة على المستوى القومي، أن يلجأ المتضررين إلى المجتمع الدولي لحماية هذه الحقوق.
وأقباط اليوم، مثل جميع بني البشر، ليسوا استثناء فيما يتعلق باستخدام آليات العدالة المشروعة هذه، فهم يعانون من اغتصاب مُمنهج لحقوقهم الأساسية حتى الحق في الحياة، ولم يُقدم أي من مرتكبي هذه الجرائم للعدالة، الأمر الذي أدى إلى شيوعها وتصاعدها، عبر أكثر من ثلاثة عقود، وبات الأمر ينذر بتطورها إلى عمليات إبادة جماعية فى هذه الظروف التي تمر بها مصر الآن حيث لا أمن ولا قانون، وسط مناخ مشحون بالتعصب والتحريض ضدهم، ومتربص بهم للعدوان عليهم تحت ذرائع مختلقة واهية.
أن جسامة الجرائم الإنسانية التي يتعرض لها الأقباط، والتي عبر عنها تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية فى اليوم الأول من عام 2011 قبيل سقوط رأس النظام البائد، وما تلاها من جرائم جماعية حدثت بعد سقوط رأس ذلك النظام تؤكد فشل الجهات الإدارية والسلطات المحلية فى الوفاء بواجباتها تجاه المواطنين الأقباط تحديدا ، وتواطؤ بعض أجهزتها ومشاركة عناصر منها فى تنفيذ كل هده الجرائم والإنتهاكات الحقوقية.
الواقع الذي أدركه مؤخرا مسلمون مصريون شرفاء إن ما يتعرض له الأقباط، هو جزء من كل ما تتعرض له مصر كلها، فلا تزال سياسة النظام البائد مستمرة: وأحد أساليبها إشعال "الفتن الطائفية" أو عدم إطفائها، إلا بعد تحقيق الهدف منها، هذا على الرغم من الآمال التي كانت معقودة على ما عُرف "بثورة 25 يناير" لدى كل المصريين، وخاصة الأقباط.
فى ضوء كل ذلك، أصبح واضح جدا أن مصر في مفترق طرق، ولذلك لا يصحُ لأي إنسان أو مؤسسة أن تتحمل مسئولية السكوت أو تمرير هذه الجرائم والتي توالت عبر أربعة عقود، دونما حساب، فباتت الآن تهدد الجميع، بل وتقلق المجتمع الدولي ممثلا بهيئة الأمم المتحدة وكل الدول المتحضرة وشعوبها الحرة.
وبينما لم تبدى الحكومات المتوالية أي جدية لإتخاذ الإجراءت اللازمة لوقف هذا المسلسل البغيض، تأكد بشكل فاضح فشل معالجة المسألة القبطية من منطلق طائفي في معزل عن المسألة الوطنية وضرورة تناولها من خلال الآليات السياسية والقانونية المحلية والدولية، إذا لزم الأمر، فعمل كل هذه الآليات في نهاية الأمر يصب فى تحقيق العدالة العامة والتحول الديمقراطي واقتلاع الفساد السياسي والاستبداد بطريقة سلمية، أو بما يُعرف بالضغط الناعم .
وفى ضوء ما سبق يصعب التكهن بأن يكون للتوافق المنفرد، بين المؤسسة "الكنسية" المصرية ومن هم فى الحكم الآن ، أي مردود إيجابي يخدم الأقباط ومصر بوجه عام من جهة تأسيس مصر المستقبل بنظامها الديموقراطي الحق ودولة القانون.
فشواهد الأمور تؤكد لنا أن هذا "المستقبل" لا يُعقل انتظاره إستجابة لوعود سبق التنكر لها والإلتفاف حولها. فالمستقبل الآمن والمبتغى يجب أن تكون له بوادر آنية وأسس قوية توضع اليوم ونلمسها، ويواصل الجميع العمل الجاد والملتزم من أجل تحقيق بقية هذه الأسس لإتمام عملية بناء الدولة المصرية الحديثة المستقرة.
ولكي أكون أكثر تحديدا أقول: كان من المفروض على من هم فى كرسي السلطة أن يحققوا العدالة الإنتقالية فى كل ما تعرض له الأقباط من مذابح واعتداءات جماعية وفردية على أساس هويتهم الدينية، كما كان على من يتولون إدارة شئون البلاد فى هذه المرحلة الحرجة أن يوفوا بحقوق أهالي مئات الشهداء وآلاف المصابين ضحايا النظام البائد وفلوله، وفى النهاية معاقبة كل من شارك فى نهب ثروات الشعب وانهيار مؤسسات الدولة وإفساد الحياة المصرية بكل مناحيها السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فهل يمكن الآن تصحيح المسـار؟ هناك شكوك منطقية قوية فى إمكانية تحقيقه. هذا إحساس تكون على مدى شهور وله خلفيات من زمن النظام البائد لدى جموع المصريين الذين يعيشون المأساة والألم والحلم، إذ يؤكدون أن التركيبة السياسية الحالية لا تبشر بتصحيح المسار بذاتها.
و يبدو لي إنهم توصلوا إلى قناعتهم هذه بعد تحليل الأوضاع المصرية قبل وبعد 25 يناير و إلى الآن. فقد ثار الجدل حول ما إذا كانت مصر قد شهدت ثورة أو "فورة" أو حركة عصيان عام.
وهذا أيضا ما تأكد لي شخصيا، وخاصة بعد مقابلة بعض قيادات شباب ما أُعتبر أنه "ثورة" والحديث معهم مؤخرا فى مؤتمر بواشنطون، على مدى ثلاثة أيام، إذ لم يستطع أحد منهم الحديث عن متطلبات المرحلة الإنتقالية التي تمر بها مصر، أي أسس وملامح التحول الديموقراطي. بالإضافة إلى ما شاهدناه من تخبط فى عملية إدارة البلاد وفشل محاولة تهيئتها للعبور بسلاسة إلى بداية عصر جديد.
إننا كنا بالفعل أمام حركة عصيان شعبي عام فى مواجهة نظام دولة تآكلت أسسها بعد أن ضربها الفساد، فلم يستطع حاكمها الأوحد السيطرة على دفة الإدارة ومواصلة الحكم. ولم يتمكن هؤلاء الشباب من ملء الفراغ بعد السقوط! فلم لم يدر بخلدهم إنهم على ميعاد بثورة يسقطون بها النظام ولم تكن لهم رؤية لإعادة بناء دولة.
لقد أكدت القيادات الشبابية التي حركت ملايين المصريين بإستخدام الإنترنت انه لم يدر بفكرهم أية أهداف إلا المطالبة بإحداث تغيير سياسي وإصلاح دستوري فى إطار المبادئ التي كان قد نادى بها مثقفون مصريون ونشطاء منظمات المجتمع المدني عبر أكثر من عقد من الزمن ومعهم رموز من القضاء المصري.
من هنا، إذا كنا حقا نسعى إلى إنقاذ البلاد ونقصر من هذه المرحلة الضبابية، لابد من وجود تجمع وطنى قوي يشمل كل الفصائل الساعية لإقامة الحكم المدني الديموقراطي، معبرا عنِ العقل الجمعي القادر على التحرك بسرعة لإعلان الرؤية القومية وإستراتجية تنفيذها على أرض الواقع. ويبدو أن الدكتور/ على السلمي يحاول العمل فى هذا الإتجاه، بخلق توافق بين كل الفصائل السياسية حول وضع مبادئ حاكمة لدستور مصري جديد.
عندما يحدث هدا يمكن أن نقول أن "الثــــورة" بمعناها الكامل قد بدأت، وحينها يمكن أن نتحدث ونضع تفاصيل مرحلة التحول الديموقراطي وأسس الدولة الحديثة، وفى قلبها دستور مصر، الأساس الأول للدولة العصرية: دولة الرفاهية والمواطنة، دونما تردد، أو تخوف من عناصر رجعية، أو بقايا فلول النظام الفاسد البائد.
و فى المقابل، إذا لم يتحرك المصريون فى هذا الاتجاه، فسيُطل علينا الاستبداد، وبقوة، لتستمر آلام الأقباط ومعاناة المسلمين معا.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :