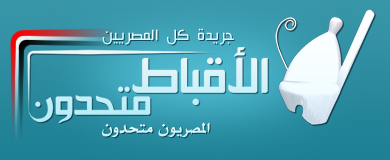في التنظيم الاجتماعي
بقلم: سهيل أحمد بهجت ـ كاليفورنيا
إن كون الإنسان مغمورًا ومحاطًا بأسباب المعيشة، وأن الآباء والأمهات كانوا طوال التاريخ وإلى اليوم يقضون حياتهم كلها في مراحل مختلفة من القلق والعمل المضني والجهد في سبيل ضمان مستقبل الأبناء و البنات، ولا أظن أن هذا يختلف من مجتمع إلى آخر إلا قليلًا، غير أن الأسلوب الغربي في تنشئة الأبناء هو الأكثر فعالية وإن كان له سلبيات، ونحن نعلم أن لكل شيء إيجابياته وسلبياته لأن كل موضوع يحكم عليه كل ناظر من جهته التي يراها وغالبًا ما يكون التأثير العاطفي والبيئي دور في هذه الأحكام، فما يراه "جلال أمين" و"المسيري" أمرًا سلبيًا حينما يرون العائلة الغربية تفضل انفصال أبناءها البالغين في سكن منفصل، ترى العائلة الغربية في هذا شيئًا إيجابيًا جدا يمكننا وصفه بأنه إعداد لهذا الجيل الجديد نحو المسؤولية واحترام الجهد والعمل، وبالنتيجة يكون هذا الإنسان مستعدًا للانسجام مع المجتمع المنظم والقانوني، كما أن التخفيف عن الآباء والأمهات بهذه الطريقة يتيح إيجاد نوع من البيئة المستقرة الهادئة عند الآباء والأمهات المسنين، على عكس الحالة الشرقية حيث نجد أسرًا كبيرة وربما حتى الأحفاد فيها بالغون ويعيشون في بيت واحد ـ غالبًا ما لا يسعهم ـ وهم محاطون ليل نهار ببيئة غير صحية من الضجيج والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية ومفتقرين إلى الخصوصية، وهذه النقطة مهمة جدًا قد يكون كثير من الباحثين قد تجاهلها، فالفرد مهما كان اجتماعيًا ـ ومهما نظّر الكاتبان وغيرهما لهذا الأمر ـ إلا أنه بحاجة أكثر أن يعيش في بيئة هادئة مسالمة تتيح له التفكير والإبداع، وحين ذلك تكون شخصيته قادرة على التجاوب الاجتماعي مع الآخرين، من هنا نجد أن انفصال الأبناء البالغين ليست مسألة اقتصادية فقط، كما أرادنا "المسيري" أن نظن، بل لها أهداف بيئية واجتماعية تتجاوز مسألة المداخيل والادّخار.
إن التنظير يختلف عن الواقع غالبا، فالتنظير قادر على تغيير الحقيقة أو تصوير الواقعة أو الموضوع سلبا أو إيجابا، و كلما كان الموضوع بعيدا عن ذهن المفكر زادت قابلية التصديق، ومواطننا الشرقي ـ وهو في الغالب محصور في بيئته وبلده ـ سريع التصديق في مثل هذه الأمور خصوصًا أنه يولد ويعيش ويموت دون أن يرى بيئة ومجتمعًا مختلفًا عن مجتمعه، من هنا نجد أن قراءتنا للكتب الاقتصادية الغربية، وخصوصًا تلك الكتب التي صاحبت ظهور الماركسية ونظريات صراع الطبقات الكادحة ضد البرجوازية الصاعدة، فإننا سنتخيل مجتمعًا آليًا وكأنه عديم الشعور، لكن ما أن تقرأ مؤلفات المفكرين الإنسانيين إبان الثورة الفرنسية، أو مؤلفات "جون ديوي" John Dewey 1859 ـ 1952 مثلًا، فإننا نبدأ حينها فقط باستشعار التنوع والاختلاف وتعدد الأنماط، بدلًا من النمطية المزعومة، في المجتمعات الغربية القائمة على التغيير، وإذا كان الكاتبان هنا يردّدان أن الغرب أغرق المجتمع والفرد بتحويله إلى أرقام وإحصاءات، فإن ذلك لا يعدو كونه وصفًا غير واقعي لما يمكن أن يكون من باب اطلاع الفرد والمجتمع على المنجزات والمشاكل والحلول الاقتصادية، وهنا نحن أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن يستمر المجتمع في الاطلاع على واقعه الاقتصادي ودرجات النمو، وهذا غالبًا ما يكون محصورًا أو حكرًا على المهتمين وذوي الاختصاص، أو تجاهل هذا الجانب والإغراق في التوكل على الأقدار والنصيب والحظوظ، وهي السّمة الملازمة للمجتمعات التابعة والمتخلفة، التي تقنع نفسها بأنها أغنى من حيث "القيم الخلقية و الروحية" وهي في الواقع تعيش كارثة حقيقية حيث لا أخلاق ولا واقع اقتصادي إيجابي، فلا تكاد تجد في مجتمعات الغرب طبقية مجحفة لأن أدنى الناس وأفقرهم يمتلك كل أساسيات الحياة المهمة، ومن ثم يحاول المسيري، وعبر تعابير جلال أمين، أن يتخطى الحقيقة الاجتماعية في أن المجتمع العلماني الصناعي أكثر استجابة لحاجات الإنسان من الدول المتخلفة التي تفلسف الدولة ـ هذه المؤسسة الأرضية الدنيوية ـ على أسس روحية أو حتى مادية مثالية ـ كالفلسفة الماركسية ـ التي انتزعت الإنسان من المادة لترده إلى قوانين مثالية خيالية تم عبرها قتل الفرد بحجة الحفاظ على الكل.
و المثير للدهشة هو الحديث عن افتقار الفرد في المجتمع العلماني إلى "حد أدنى من الشعور بالأمن و الاستقرار"، فالغربي بعد أن تمكن من التغلب على العوائق المادية المتحكمة بالواقع يبدو لنا "قلقًا" والحقيقة أن هذا القلق ناتج عن تفرغ الغربي للتفكير والبحث وطرح ألف سؤال وسؤال، بينما إنساننا الشرقي ولأنه مسحوق اقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا من خلال حياة مليئة بسلسلة تجارب فاشلة فهو يبدو لنا "مستقرًا و آمنًا" والحقيقة أنه لا يجد وقتا لطرح الأسئلة أو التعبير عن التعجب أو الاحتجاج، بعبارة موجزة هو مواطن مدجن بكل معنى الكلمة وبكل ما للتعبير من معنى، وحتى في العلاقات الاجتماعية يعيش غالبية الغربيين تجارب متعددة و الفرد الواحد منهم يمتلك من الاطلاع على عدد من المجتمعات ما قد يفوق أحسن تجاربنا، والمسيري واحد من هذه العقليات الشرقية المعزولة والمنطوية على ذاتها.
وهكذا نستمر مع المسيري في دائرة مفرغة من الأسئلة، فلكي نواجه مشاكل العصر الصناعي والعولمة والطفرة الكبرى في عالم المعلومات والاتصالات والانتقال السريع، علينا أن نتخلص من الدكتاتورية والاستبداد والأمية والفساد والتعصب، وغيرها من المصطلحات السلبية الضخمة التي تتحكم بمجتمعاتنا، والاستقرار المعني ها هنا حسب المسيري يشبه بنظري الاستقرار الذي تعيشه القبائل التي تعيش في الغابات المطرية أو الأعراب الذين كانوا يأدون أطفالهم أحياء كنوع من سنة الحياة، وبالتالي نظروا إلى منع الإسلام لهذا الفعل على أنه "بدعة"، هذه المجتمعات تعتبر تقاليدها و أعرافها (استقرارًا نفسيًا)، وفي الواقع وحينما تتسع مدارك الإنسان ويصبح مطلعا وعارفًا بقوانين الحركة والأسباب والمسببات، يبدأ في إطلاق أحكام موضوعية على الأشياء، ويصبح الاستقرار ركودًا والقناعة غفلة وهبلًا و غباءً، فالجاهل قد ينعم بجهله ولكنه بالتأكيد يختلف كلّيا عن ذلك الإنسان الواعي الذي يعيش "هموم التفكير" واستخدام العقل، من هنا فإن المجتمعات المتخلفة تعيش على راحة نفسية "وهمية" بينما الواقع يؤكد أنها مهددة وعلى حافة الكوارث واستغلال ذوي النفوذ.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :