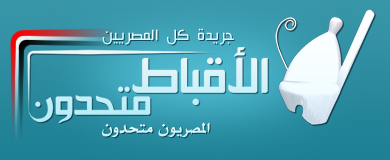- "يسرا" و"عادل إمام" و"السقا" و"عبد الله كمال" و"تامر أمين" و"الفقى" على "قوائم العار" لتحريضهم ضد الثورة
- بلاغ للنائب العام والحاكم العسكري لاختفاء مسيحية بالمحلة
- حملة تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر للرد على العلمانيين!!
- كاهن كنيسة مار جرجس بـ"العريش": تلقينا تهديدات بالاعتداء على الكنيسة فجر السبت
- مهما تعملي فيا برضو غالية عليا.. بحبك يا مصر
شخصيتك هي ما أنت فاعله في السرّ دون العَلَن
لورد بايرون "Lord Byron" من كتابه "Don Juan" تحدَّيات الوحدة والتكامُل
بقلم: راندا الحمامصي
ليس بمقدورنا بلوغ حياة متكاملة صحية نافعة وخلاّقة ما لم نُدمج معًا تلك الأبعاد البيولوجية والسيكولوجية والروحانية لحياتنا لتصبح مكوِّناتِ حقيقة واحدة متّحدة الأركان. لقد غاب عنا هذا التكامل الضروري وافتقدناه تمامًا لأن البصائر العلمية والروحانية التي نملكها لم تكن في المستوى الذي يؤهلنا لبلوغه إلى أن جاء منتصف القرن الماضي. فلدينا الآن ذخيرة من المعرفة تكفينا لأن نحظى بهذا التكامل، وأن نخطو تلك الخطوة الإستثنائية الجبارة نحو معرفة الذات.
فمن أجل حياة سليمة، وإقامة علاقات متنامية متناغمة، وتكوين أُسَر سعيدة، وتأسيس مجتمعات تقدُّمية، وارتفاع دعائم سلام عالمي، علينا التعرُّف حتمًا على الجانب البيولوجي والسيكولوجي والروحاني من حقيقتنا كإنسان، ونأخذها حُزمة واحدة متكاملة نحو حياة صحّية نافعة وسعيدة مُفعمة بالتفاؤل والأمل.
إن معرفة الذات ليست أمرًا نعتبره من الكماليات، بل هي ضرورية ومطلب رئيس لبقاء الجنس البشري. فلو نظرنا إلى ماضينا لوجدنا نمطًا من الحياة كان الفرد فيها يُولَد في الأسرة ويبقى ضمن نطاق القبيلة ويعيش في مجتمع صغير ويعمل في مجال محّدد له ويقضي عمره على هذا النحو إلى أن يموت دون أن يحقق أكثر من محاولاته التغلّب على مصاعب الحياة من أجل البقاء. وحتى في عصرنا هذا هناك مجموعات كبيرة من الناس لا يزالون يعيشون هذا النمط وتلك الظروف الحياتية، ومع كل ذلك نجد الآن دلائل واقعية تبشّر بالتغيير.
فالتقدم العلمي الهائل في مختلف الميادين قد سهّل على الناس سبل انتقالهم واختلاطهم، وأزال تلك الحواجز التي أبقتهم متباعدين في جهل. لقد ولّى عهد العزلة وأصبحنا في عصر التعايش الاجتماعي وفي طريقنا نحو التكامل. ونتيجة لذلك فإن المجتمع الإنساني يشهد اليوم مستويات أعلى من المعرفة الذاتية والوعي والإدراك.
فالوعي يولِّد التغيير، وهذا هو السبب في أنه عندما يحصل وعي جديد في حياتنا، ونراه يأتي في شكل دين عالمي جديد مثلاً، نشاهد موجات التغيير تَطال مختلف جوانب الشئون الإنسانية. إن العامل الرئيس في عملية التغيير إدراكٌ تام ويقين بأن الحقيقة الإنسانية هي الصانع الجبّار للوحدة والإتحاد. فما الحياة إلا وحدة واتحاد وفي الوحدة حياة.
الحياة وحدة واتحاد
تبدأ الحياة بإتحاد غامض بين المادة والوعي (الروح أو العقل). ففي عملية نجهلها تمامًا تُشحن المادة، بجميع مكوّناتها، بالوعي فتسري فيها الحياة. ومنذ تلك اللحظة تبدأ مسيرة التطور من خلايا حية إلى كائنات بسيطة التركيب ثم إلى أشكال حياتية متطورة أكثر تعقيدًا. من صُلب جميع تلك العمليات الحياتية حدث بروز حالات أرقى من حالات اتحاد المادة بالوعي إلى أن وصل الأمر إلى النوع الإنساني لتبلُغ عملية الإتحاد تلك سَمْتَها وذروتها، وهناك تبدأ مرحلة جديدة نحو التطور الأعلى لنماذج وأشكال من الوحدة غير بيولوجية في جوهرها.
ففي الإنسان الصحي السليم تتجلى أبعاد الوحدة الثلاثة بالكامل: البيولوجي والسيكولوجي والروحاني. دعونا نستعرض كلاً منها باختصار.
البُعد البيولوجي للوحدة
إن حياة الإنسان هي ثمرة تزاوج الجسد والعقل. فحالما تبدأ الحياة نأخذ في التعلُّم والتفهّم واختبار أنفسنا بأسلوب متكامل سليم. فجسدنا وعقلنا كلاهما يحددان لنا شخصيتنا كإنسان، ولا يجوز بل لا يمكن استثناء أحدهما. نشعر بالجوع، ونحمل الرغبات المتعددة ونمرّ بتجربة الفرح والحزن والغضب والخوف والاضطراب ثم الأُلفة والمودّة... وهكذا. لدينا الأفكار وموهبة الحدْس والتخمين ثم الإلهامات والآمال والتطلعات ونتّخذ القرارات ونضع الحلول. فنحن هذا كلّه، بل ونتعرّف على أنفسنا أيضًا من خلال كل ذلك ونختبرها في كل هذه الظروف والحالات. إننا التنوع والتعدد بعينه، ومع ذلك نشعر بأننا واحد، بل حقًا إننا واحد رغم شعورنا بالتنوع. نحن كَوْنُ بحد ذاتنا. إننا نملك هذا الثراء الكبير كوننا حائزين على ذلك التنوع في الحالات التي تبدو متناقضة. نعم، لأننا مولود أرقى وأرفع مستوى من الوحدة؛ وحدة الجسم والروح، وبدونها نُعتبر شيئًا لا يُذكر.
من مآسي العلم الحديث أنه يسعى إلى تقليص قيمة الظواهر الإنسانية محوّلًا إياها إلى مجموعات من التفاعلات البيولوجية المعقدة. فهو يتغاضى عن الروح على أنها حقيقة مستقلة بكل مواهبها وقواها وأفعالها، بل إن العلم الحديث يتنكر لوجود الروح أصلًا. والنظرة المادية العالمية تختزل حقيقتنا الإنسانية لتضعها في مرتبة الآلة، وأننا مجرد آلة تعمل.
ومع ذلك، حتى أولئك الذين يحاولون وضع الروح في المرتبة الأولى يصطدمون بنوع مختلف من الشَّرَك، وذلك في إنكارهم حقيقة أن أفكارنا وأحاسيسنا وقراراتنا لا يمكن لها أن تتشكّل إلا بالعمليات الكيميائية الحيوية والبيولوجية التي يعتبرها العلماء الماديون كتلة الكيان البشري. لا شك أن في حياتنا الدنيوية لا يمكن للروح أن تعمل دون الجسد، وبالمثْل لا يمكن للجسد أن يعمل دون الروح. فالوحدة البيولوجية – وحدة الجسد والروح – مطلب أساسي للحياة ولتفرُّد ذاتنا. إن لغز ازدواجية الجسد والروح لا يمكن حلّه لا بإنكار الروح ولا في تجاهل الجسد. بل لو استطعنا إدراك حقيقة الوحدة القائمة بين الجسد والروح لزالت مسألة الازدواجية من عقولنا وتمَهَّدَ الطريق أمام التطور الإنساني للتعبير عن ذاته في مراحل أرقى من الوحدة.
البعد السيكولوجي للوحدة
إن الإنسان حائز على غرائز ضرورية للحفاظ على حياته، وفيها يشارك الحيوان أيضًا. فهذه الغرائز تقوم بوظائف مختلفة وكلها تهدف إلى الحفاظ على الفرد وعلى الجنس البشري. فغرائز من قبيل الشعور بالجوع ثم الكرّ والفرّ حين القتال والرغبات الجنسية إنما تعمل لتضمن تغذية جسمنا والدفاع عنه ضد الهجوم وحمايته بالفرار من الخطر والحرص على بقاء الجنس البشري. ففي حقيقة الأمر نقضي جزءًا لا بأس به من حياتنا في الحفاظ على وجودنا.
وحتى لو فزنا بالبقاء أحياء وحصلنا على الطعام الكافي والمأوى المناسب ورعاية صحية سهلة لا نقوى على توفيرها بأنفسنا، ورزقنا بطفليْن أو أكثر وعشنا في مكان آمن وبيئة مسالمة، فإن الكثير منا يبقى يقضي أيام عمره في البحث عن المزيد مما يلزمه من أجل البقاء (مثل النقود الأكثر والمنزل الأكبر والطعام الأوفر... إلخ) ويتصرّفون وكأن بقاءهم مُهدّد بالخطر.
كل ذلك بسبب جهلنا بقانون الوحدة وأصولها. نحن لا ندرك أن بقاءنا لا يعتمد بالكلية على أنفسنا منفردين، وإننا في حاجة إلى بعضنا البعض. فعندما نكون أطفالًا نحتاج إلى والديْنا وآخرين بالغين، وعندما نصبح بالغين يحتاج بعضُنا بعضًا. فالإنسان لا يمكن له أن يعيش منفردًا، ومع ذلك نسلك وكأن الآخرين أعداء لنا، وكأن بمقدورنا أن ننأى بحياتنا عن الآخرين ولسنا بحاجة إلى مساعدنهم. وحيث إن مفهومنا عن الوحدة لا يزال بدائيًا، فقد وضعنا لأنفسنا نمطًا من الحياة يتّصف بعدم الثقة بأنفسنا وبالآخرين وبعدم الشعور بالأمان في مستقبلنا. وفي النهاية وجدنا أنفسنا نشعر بأن علينا أن نقضي حياتنا في سبيل أن نضمن وجودنا. أما في رحاب الوحدة فيبدو الأمر مختلفًا تمامًا؛ إذ علينا أن نضمن تسخير غرائزنا وعواطفنا وأحاسيسنا بأسلوب بناء لا مدمّر هدام. وفيما يلي ما يزيد هذه النقطة وضوحًا.
بغريزة الجوع نتلقى الأمر بضرورة تناول الطعام، فإذا ما أفرطنا في ذلك أو قلّلنا منه أو كان الطعام رديئًا نكون قد عرّضنا صحّتنا للخطر، وفي النهاية هدّدنا وجودنا. وبالمثل فإن غريزة الكرّ والفرّ هي قوة لحمايتنا، ومع ذلك فلو أن كل إنسان تسلّح ببندقية لحماية نفسه، وكل أمة صنعت الدبابات والقنابل والطائرات الحربية لدرء الأخطار عنها، وإذا ما غدا العالم مستودعًا للأسلحة الفتاكة الكافية لإبادة الجنس البشري من على وجه الأرض عدة مرات، عندها لن يكون أحد في الوجود آمنًا. فالأمن والأمان إذن أكثر من كونه ثمرة الوحدة والإتحاد، فهو الذي يحافظ على بقاء الجنس البشري. فبقاء الفرد معتمد على بقاء المجموع ويصعب بقاؤه دون الآخرين.
وعندما نتوصل إلى مستوى تعمل فيه غرائزنا في وحدة متكاملة يكون بإمكاننا الإهتمام بمشاعرنا وعواطفنا، وعندها سنتساءل في أنفسنا ما الذي سيوفّر لنا السعادة أو يوقعنا في مهاوي الشقاء؟ ما الذي يمنحنا الشعور بالثقة أو يولّد لدينا الشك والإرتياب؟ ما الحالات التي تسبب لنا الخوف أو تمدّنا بالشجاعة والإقدام؟ ما الذي يجلب لنا القلق والاضطراب أو يمنحنا الهدوء والاطمئنان؟ بهذه الطرق المختلفة نختبر أنفسنا. إلا أنه في النهاية نشعر بشيء من الصراع الداخلي. فإذا كنا ننشد الوحدة الحقة في عواطفنا ومشاعرنا علينا التوفيق بين مشاعر متضاربة من قبيل الفرح والحزن، الراحة والعناء، الحرية والانضباط، إذ هناك الكثير من مثل هذه الحالات المتضاربة عند الناس تتسبب لهم في نوع من الصراع الذاتي. ومع ذلك فإن المجموعات الثلاث التالية من تضارب المشاعر كافية لتوضيح الفكرة من وحدة هذه المشاعر.
فالفرح، فوق الجميع، يعتمد على مدى توحّدنا في شخصيتنا واتحادنا مع الآخرين في علاقاتنا. فلو عشنا حياتنا في وئام وانسجام وتكامُل مع أفكارنا ومشاعرنا وأفعالنا وباتحاد مع الآخرين، نكون عندها سعداء فرحين، أما لو كنا نعاني من تشتيت وبعثرة في داخلنا (ما بين ما نفكر فيه ونحسه ونفعله)، وكان هناك صدع في علاقاتنا مع الآخرين سنكون بالطبع تعساء.
هناك نوعان من الحزن؛ نوع ناتج عن عدم التوحد والتكامل، وآخر ناتج عن افتراقنا عن شخص نحبه ونود أن نبقى قريبين منه. في الحالة الثانية يمكن للفرح والحزن أن يجتمعا معًا. فمثلًا أنا سعيد بعلاقتي الجيدة مع زوجتي، وحزين لأنني سأسافر وأفارقها.
ينطبق الشيء نفسه على الراحة والعناء. كلنا يرغب في الراحة، وليس من السهل تحمُّل الألم. إلا أن الألم ضروري لبقاء الإنسان. فلولا الشعور بالألم لهلكنا من المرض؛ لأننا بدونه لا ندرك أي خلل صحي. ليس هناك من تطور ونماء دون معاناة وألم، فكلاهما لازمان لصحتنا ونمائنا وغير مريحيْن أيضًا، وسنكون أكثر عناءً إذا فوّتنا على أنفسنا فوائد تجربة الألم والمعاناة.
إنه مصدر راحة لنا كوننا نعلم بأننا سنتألم إذا ما أصابنا مرض، وهو إشارة الخطر التي تدعونا إلى فعل شيء ما لمعالجة الخلل. ثم إنها مصدر راحة أيضًا لأننا ندرك أن المعاناة في الحياة يمكن توظيفها في خدمة نمو قدراتنا ومواهبنا وتطوّرها. لذا فإن حياة دون معاناة ودون نموّ وتطور تكون غاصّة بالآلام والمعاناة. ولذلك فإنه من الفهم السليم والإدراك المنطقي بأننا نتعلم من معاناتنا ونساعد أنفسنا على النمو والتطور. إنها دورة خلاقة، فكلما تعلمنا من معاناتنا خفّ شعورنا بألمها، وبالعكس كلما حاولنا إبعاد أنفسنا عن الألم والمعاناة كلما عانينا أكثر.
هناك مثال آخر فيه التضارب بالمثل نراه فيما يتعلق بالحرية والانضباط. فكثير من الناس يعرّفون الحرية على أنها تعني التحرُّر من كل قيد وانضباط. إنه خطأ شائع، إذ لا يمكن أن نحظى بالحرية الحقيقية إلا حيث يسود النظام والانضباط. فتصوّر ساعة ازدحام السيارات أثناء السير، فماذا يمكن أن يحدث دون وجود إشارات المرور الضوئية؟ قارن أحوال الناس حيث الحرية المطلقة بأحوالهم حيث النظام. لا شك أن النظام هو الذي يوفّر الحرية للجميع، والحرية المنضبطة تجعل من النظام والتنظيم صفة إنسانية. وبكلمات أخرى فإن التنظيم يحول دون شيوع الفوضى، مثلما الحرية تأبى الدكتاتورية وتنفر منها.
هذه الأمثلة عن الفرح والحزن والراحة والعناء والحرية والانضباط تُظهِر لنا الحاجة الماسة إلى تطبيق مبدأ التوحُّد في انفعالاتنا وعواطفنا، ونأخذها حزمة واحدة ضرورية لحياتنا، فبدل أن نتفادى حالات معينة غير سارة مثل الحزن والمعاناة والانضباط، علينا أن نحاول إدماجها في خبراتنا الحياتية. وعندها نجد أنفسنا نتمتع بحياة أقل جزعًا وفزعًا وأكثر انسجامًا ومواءمةً.
أما الوجه الثالث للوحدة السيكولوجية فنجده فيما يتعلق بالمفاهيم والأفكار. فالمفاهيم هي خاصة بالإنسان دون غيره، إننا نملك الوعي والقدرة على الفهم والاكتشاف وموهبة التأمل وتكوين المفاهيم. نمتلك المعرفة عن طريق التفكير والإلهام وحب الاستطلاع. إنها قدرات وطاقات تحدِّد وتشكِّل لنا شخصيتنا ونوعية حياتنا؛ مَنْ نحن وكيف نعيش؟ هذا ما يحدده لنا تفكيرنا. لذلك يغدو من المهم أن نمنح أفكارنا قدرًا مساويًا من الإهتمام بمشاعرنا على الأقل. ومع ذلك نجد أن أغلب الناس عمليًا يتجنبون التمعن عميقًا بما يجول في أفكارهم. نحن نفكر كثيرًا بما نحتاجه وبما نريده وبما نشعر به، إلا أننا لا نفكر إلا لُمامًا ﺒ "مَنْ نحن"، وما الهدف من الحياة إذا تجاوزنا هدف بقاء الجنس البشري والفوز بالمشاعر الطيبة.
كلما سألتُ الناس عن الهدف من هذه الحياة غالبًا ما أُواجَه بتعابير الدهشة والحيرة على الوجوه، وربما حملت مشاعر السخط في بعض الأحيان، فيجيبون قائلين: ماذا تعني بكلمة الهدف من الحياة؟ ثم ينتقلون إلى ذكر عدد من النشاطات والمفاهيم، معظمها إن لم يكن جميعها، ينحصر في البقاء على الحياة، وعن المشاعر والعلاقات. فما يخص الحفاظ على البقاء كانت هناك إجابة بسيطة شائعة درجوا على قولها وتبقى على لسانهم: "أن نعيش حياة جيدة". ولكن ما هي الحياة الجيدة. هذا ما ليس واضحًا تمامًا. ثم يتكلمون بعد ذلك عن السعادة والاطمئنان، أو العيش حياة بسيطة لا يتعرّضون فيها للإساءة أو الإهمال.
إن تطلعات معظم الناس للحياة محدود جدًا. فآفاق الحياة تتسع كلما ارتفع مستوى الوعي، ومعظم الناس يتفادون وعيًا جديدًا في حياتهم. فهم وجِلون من أية مفاهيم جديدة لأنها ستخلق لديهم حالة من الصراع الداخلي. عادة ما ينظر الناس إلى أنفسهم: مَنْ هم وكيف تسير حياتهم من منطلق ما تعلّموه من عائلاتهم وما ورثوه من ثقافاتهم، وبهذا الأسلوب تشكّلت مفاهيمهم عن الحياة نتيجة الإمتصاص البطئ بمرور الوقت – التناضح – "osmosis" فقد تبنّوا مفاهيم أسلافهم وما هو سائد بين عامة الناس من نُظُم عقائدية يشاركونها مع بعض المجموعات. فهذه المفاهيم عادة ما تلقى القبول دون دراسة نقدية أو تأمل فيها.
إن أهم ما تتصف به هذه المفاهيم على أنها مبدأ تلك الجماعة المنتمية لعامة الناس، وبتبنِّينا تلك "المبادئ" السائدة في المجتمع نشعر بأننا "طبيعيون أسوياء". معظم الناس يعتبرونها حالة صحية، إلا أنها معادَلَة غير سليمة وتحبط العزائم نحو كل تغيير حقيقي مفيد. ومع ذلك فإن أهم مبادئ الحياة هو التغيير، لذا فإن المفاهيم عندما لا تتغير لتعكس أوضاع العالم الحقيقية ستكون سببًا في خلق وتطوير صدع جذري يحول دون الفرد والعالم المتغيِّر. فبينما العالم آخذ في التغيير والفرد جامد ملازم مكانه ستتسع الهُوة بين الاثنين بالتدريج إلى أن تصبح سحيقة مدمِّرة.
إن أعظم تحوّل في المفاهيم الاجتماعية والسياسية السائدة في عالم اليوم هو إدراكه بأن البشرية قاطبة وحدة واحدة، وأن تحقيق الوحدة والإتحاد هو محور التحدي أمام هذا التحول الاجتماعي في يومنا هذا. والسبب في هذا أنه بمجرد إدراكنا حقيقية مفهوم الوحدة الإنسانية وموقعنا فيها ستتغير نظرتنا لأنفسنا بشكل مثير حقًا. سوف لا نرى أنفسنا وحيدين نعيش في معزل عن الآخرين، ولا في صراع دائم وتنافس مع غيرنا، ولن نفقد الأمل والقدرة على مواجهة التغيُّرات السريعة التي تحصل في عالمنا. بل على العكس من ذلك سوف ندرك بأننا جزء من أبناء الجنس البشري قاطبة، وأننا ننتمي إليه ككل، ويمكننا بذلك أن نحقق المزيد من إنجازاتنا بتأسيس دعائم السلام ومدّ جسور التعاون بين الشعوب، وأننا معًا قادرون حقًا أن نحدّد ونقرِّر اتجاه التغييرات الحاصلة في حياتنا وطبيعتها.
وأكثر من ذلك، فإن وعينا بالوحدة وإدراكنا لثمارها يقوّي لدينا شخصيتنا الفردية ويصون تنوّعنا، ويخلق ظروفًا نستطيع فيها، بما يميّز شخصياتنا كأفراد وما فينا من مواهب مختلفة وقدرات وما نحمله من مفاهيم، أن نبني عالمًا يتّسع للجميع ويخصّ الجميع ويخدم الجميع.
يميل الناس إلى الاعتقاد بأنه في سبيل جعل حياتهم أفضل، عليهم أن يركّزوا جهدهم على مصالحهم الخاصة وبالأكثر على أوضاعهم وأوضاع عائلاتهم. فاتجاه كهذا يأتي بالنتيجة العكسية. فعندما نهتم بأنفسنا في المقام الأول نحدّ بذلك من عالمنا ونجعله صغيرًا جدًا مما سيقلّص أمامنا الفرص والخدمات المتاحة. فأيهما أفضل أن تكون جزءًا من عائلة مُحِبّة ودودة مكوّنة من ثلاثة أفراد، أم من أسرة طيبة أوسع تعاطفًا ومودة مؤلفة من ثمانية وثلاثين فردًا مثلًا؟ أليس من الأفضل أن تنتمي إلى عالمٍ موحّد بدل أن تنتمي إلى دولة، حتى لو كانت قوية، تعيش بين دول أخرى متنافسة؟ في أي الحالات سنجد أمامنا الفرص الأكبر لتطورنا الذاتي؟ فالوحدة تزيل من أمامنا كل العوائق وتوسِّع آفاق الفرص والإمكانيات.
إن أحد المواضيع الرئيسة الواردة في العلاج النفسي "psychotherapy" موضوع الأنانية. إذ يمكننا التعرّف على الآثار السقيمة وغير السارة عند الأنانيين بكل يسر وسهولة من مدى انعكاس تأثيرها على حياتنا. فعندما يذكر الناس تلك العائلات التي تعاني من أزمات، وحالات الزواج المضطربة، والأشخاص المدمنين، والبيوت المفتقرة إلى المحبة، فإنهم يستفيضون في ذكر الأنانية وحب الذات عند والديهم أو عند طرفي الزواج أو أقاربهم أو أصدقائهم وعن أنفسهم أيضًا. فكلما بالغ الشخص في التركيز على نفسه كلما بعُد عن الآخرين. فلا يمكن للإتحاد والأنانية أن يتّفقا، فهما أمران لا يجتمعان على الإطلاق، فمن يرغب في الإتحاد عليه أن ينبذ الأنانية بالكلية.
وجدتُ أن أكثر تغيير مثير للإعجاب ويسترعي الإهتمام، ذلك الذي يحدث عندما يُنَحّى حب الذات جانبًا ليفسح المجال أمام الذات للتوجه نحو الآخرين. إنها منقبةُ "الوُجهة الأخرى" "other directedness". وبكلمات أخرى فإن التغيير يأخذ طريقه عندما يبدأ الشخص يدرك تمامًا أن تحقيق وحدة العالم الإنساني يتطلب منه تحسين حياته الفردية دون الخروج عن إطار الحياة الجماعية وعالمها. إن مفهوم "الوُجهة الأخرى" في سياق الهدف الأسمى للوحدة والإتحاد يختلف اختلافًا جذريًا عن العطاء المجرَّد من النيّة في تطوير شخصية المتلقّي وحياته. فنحن معشر البشر علينا أن نضع أنفسنا ونُبقيها في ميدان العمل، وعلينا أن نحقق ذلك ليس بالعمل بمفردنا بعيدًا عن الآخرين بل بإشراكهم معنا في مجهوداتنا. فهي عملية رائعة تضعنا على قدم المساواة مع الآخرين في خدمات مفعمة بالمحبة والعدالة.(من سيكولوجية الرَّوحانية)
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :