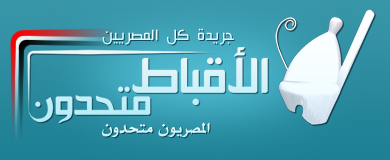في مواجهة ثقافة التدمير
بقلم: د.عبد الخالق حسين
لا شك عندي أبداً، أن ما يجري في العراق من صراعات، هو نتاج الثقافة العراقية (أي موروثنا الاجتماعي والسياسي
= culture) وخاصة منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 ولحد اليوم، وهو امتداد للماضي، إذ كان العراق في أواخر العهد العثماني وأوائل الدولة العراقية الحديثة، عبارة عن خرائب وأنقاض، وشعبه منقسم إلى عشائر وفئات متناحرة، وفي حرب دائمة فيما بينها، وعلى الحكومات المتعاقبة، إلى حد أن قال عنه الملك فيصل الأول، أن أهل العراق لم يصلوا بعد إلى مرحلة الشعب.
فمنذ تأسيس الدولة العراقية إلى سقوط العهد الملكي عام 1958، ساهمت النخب المثقفة (الإنتلجنسيا العراقية) بكل شرائحها: العلمانية، والسياسية، والدينية، بتحقير الدولة العراقية، وتحريض الشعب ضدها، ونعت العهد الملكي وجميع رجالاته بالشر المطلق، وأنهم خونة عملاء الاستعمار، وأعداء الشعب، بحيث أثاروا عليه نقمة الشعب والجيش إلى أن نجحوا في إسقاطه في ثورة 14 تموز 1958، وعندها فتحوا صندوق الشر (Pandora box)، أو عش الدبابير، فانفجر الصراع الدموي بين نفس القوى السياسية التي حرضت ضد النظام الملكي وساهمت في إسقاطه.
وبعد سقوط العهد الملكي، وبدلاً من أن يستجيبوا لمتطلبات مرحلة ثورة 14 تموز ويحموا منجزاتها، انشغلت القوى الوطنية في صراعات دموية فيما بينها، فأراد اليساريون من قائد الثورة ورئيس الحكومة، الزعيم عبدالكريم قاسم أن يكون كاسترو العراق، ورفعوا شعارات غير مناسبة للمرحلة، استفزوا بها دول الجوار والدول الغربية في مرحلة كانت الحرب الباردة على أشدها، مما أعطى تصوراً للعالم أن عبدالكريم قاسم مقدم على إعلان النظام الشيوعي في العراق!!
كما وطالبته قوى التيار العروبي، بإلغاء الدولة العراقية، ودمجها بالجمهورية العربية المتحدة، في وحدة اندماجية فورية "ما يغلبها غلاب!!". وأعلن الأكراد من جانبهم ثورتهم المسلحة ضد حكم قاسم لتحقيق مطالبهم في الحكم الذاتي عن طريق السلاح وليس بالوسائل السلمية التي كانت ممكنة مع قاسم، كما قال ذلك الأستاذ مسعود البارزاني فيما بعد...
واستمرت الصراعات والمؤامرات والتحريض ضد حكومة الثورة إلى أن تكللت جهودهم بانقلاب 8 شباط 1963 العسكري الدموي، الذي اغتال أنزه وأنظف وأخلص حكومة وطنية عرفها تاريخ العراق، ودفع الشعب العراقي الثمن باهظاً وإلى الآن.
وفي عهد الرئيس الراحل عبدالرحمن عارف، الرجل المسالم الذي عرف بتسامحه وبساطته، والذي توفر في عهده هامش من الحرية والتسامح والانفتاح، ولكن مرة أخرى، أعلن جناح من اليساريين الكفاح المسلح ضد حكومته، متأثرين بالرومانسية الثورية الجيفارية، واستنساخ التجربة الكوبية. كما واتبع البعثيون نهجهم المعتاد، التآمر مع ضباط الجيش، فتم لهم ما أرادوا في انقلابهم "الأبيض" المشؤوم في 17- 30 تموز/يوليو 1968، ليغرقوا العراق في بحر الظلمات لخمسة وثلاثين سنة أحرقوا فيها الحرث والنسل، ومازال الشعب يدفع فاتورة إسقاط ذلك النظام الجائر.
ولكن مأساة البشر الأزلية، أنهم لن يدركوا الحقيقة إلا بعد فوات الأوان، أي بعد خراب العراق الشامل بعشرات السنين، حيث اعترف القائد الشيوعي السابق، والمفكر الليبرالي حالياً، الصديق الأستاذ عزيز الحاج، في مناسبات عديدة، أن القوى الوطنية أخطأت بحق العهد الملكي، حيث أعتبروا حتى إيجابيات ذلك العهد سلبيات، وأنهم أخطؤوا في تعاملهم مع عهد ثورة تموز، إذ كان المفروض بهم، دعم محور (عبدالكريم قاسم - محمد حديد) الذي كان تقدمياً وخير من يمثل تطلعات الشعب في تلك المرحلة لتحقيق الديمقراطية والاستقرار السياسي. كذلك لا أعتقد أن الصديق الحاج مازال يؤمن بجدوى الكفاح المسلح، رغم تقديرنا العميق لتضحيات شهداء تلك الثورة المسلحة المغدورة.
ولكن لسوء حظ الصديق عزيز الحاج، أنه الآن تجاوز الثمانين من العمر، وسوف لن يمتد به العمر لأربعين سنة أخرى لكي يدرك أن تحريضه ضد الوضع الحالي هو أيضاً خطأ كما كان في المرات السابقة.
والسؤال هنا: هل تعلمت القوى الوطنية والنخب الثقافية درساً من الماضي الأليم؟ الجواب كلا وألف كلا، فإنهم مازالوا يواصلون نفس النهج التحريضي الذي اتبعوه ضد العهد الملكي، وضد العهد القاسمي، وضد عهد عبدالرحمن عارف، فمازالوا يمارسونه اليوم وبإصرار شديد ضد الوضع الحالي لأنه ليس على مقاس يريدونه. وفي كل هذه المراحل، حجتهم هي ذاتها، الحرص على مصلحة الشعب والوطن. ففي العهد الملكي كان التحريض ضد عملاء الاستعمار والأحلاف العسكرية، وفي العهد القاسمي كان من أجل الشيوعية عند اليساريين، و والوحدة العربية، عند العروبيين، أما حجتهم اليوم، فهي من أجل العلمانية والديمقراطية وتحرير العراق من الهيمنة الإيرانية!! وبعبارة أخرى، إنهم يريدون للعراق ديمقراطية ناضجة كاملة من يوم ولادتها، وبمستوى علمانية وديمقراطية الدول الغربية، أي كما يقول المثل العراقي: (شاف القصر هدَّم كوخه) فنتيجة لانبهارهم بما في الغرب من رقي في الحضارة والديمقراطية، فإنهم يريدون هدم ما عندهم من ديمقراطية وليدة، أي هدم الكوخ، وقد نسوا أو تناسوا، أن الديمقراطية الغربية قد بدأت في الغرب قبل مئات السنين بحقوق بسيطة، أي بكوخ صغير وبسيط، ثم راحوا يطورونه إلى أن صار قصراً منيفاً.
فبعد أن حرر المجتمع الدولي بقيادة أمريكا، العراق من أسوأ نظام همجي عرفه التاريخ، توفرت فرصة ذهبية للعراقيين للاستفادة من تجاربهم الكارثية السابقة، ودعم الدولة العظمى لهم، فالمطلوب منهم أن يوحدوا صفوفهم لإعادة إعمار بلدهم، وبناء نظام ديمقراطي عصري، يوفر الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي لجميع أبناء الشعب، ولكن مرة أخرى، وبسبب الأنانية والمصالح الفئوية، وذهنية التدمير المهيمنة على مختلف القيادات السياسية والفكرية، انفجرت الصراعات بين مختلف القوى الفاعلة.
لذلك، فالعراق الآن هو في مفترق الطرق، تتجاذبه أهواء القوى السياسية المتصارعة، والسؤال الذي طرح نفسه هو: إلى أين سينتهي العراق: إلى النظام الإسلامي؟ أو إلى الحكم المدني الديمقراطي؟ أو إلى التشظي إلى كانتونات؟ أو عودة الفاشية البعثية؟
من الحكمة أن نكون واقعيين في أهدافنا ومطالبنا، بأن نوازن بين الرغبات وما يمكن تحقيقه على أرض الواقع في مرحلة تاريخية معينة. ولكن مشكلتنا أن معظم المفكرين والسياسيين لا يلتزمون بهذا المبدأ، لذلك نراهم في حالة دائمة من فشل وخيبة أمل، ولوم الحظ العاثر، والبكاء على اللبن المسكوب!!. وها هو الأستاذ عزيز الحاج في معظم مقالاته، وبالأخص في مقاله الأخير الموسوم (عراق التيهِ وخيبةِ الآمال..) معرباً بألم شديد عن خيبة آماله بالعراق الجديد، وكأننا قد بلغنا نهاية التاريخ، وكل شيء قد انتهى إلى الهاوية، وها هو نوري المالكي على قاب قوسين أو أدنى من إعلان حكم "ولاية الفقيه" وصار العراق محمية إيرانية...الخ
بطبيعة الحال، لم يكن متوقعاً أن ينتقل العراق بعد 40 عاماً من أبشع استبداد متخلف عرفه التاريخ، إلى ديمقراطية ناضجة بسلاسة وبسحر ساحر، فهذا الانتقال لم يحصل في التاريخ إلا مرة واحدة، وهي في البرتغال في أوائل السبعينات من القرن الماضي، وذلك لظروف تاريخية وجغرافية معروفة. فالوضع العراقي معقد وشائك، وينوء تحت ركام هائل من المشاكل المتراكمة عبر قرون.
يبدو أن هذه الحقيقة المرة لم يدركها، مع الأسف، أولئك الذين يطالبون بحرق المراحل، والقفز من مرحلة حكم البعث الجائر الطائفي القبلي العشائري الذي أعاد العراق إلى ما قبل الثورة الصناعية، إلى نظام ديمقراطي ناضج بمستوى الدول الغربية بعد إسقاط حكم البعث مباشرة. هذا الكلام قلته مراراً وتكراراً، وأنا مضطر لإعادته الآن، لأن هناك مازال من ينكر هذه الحقيقة، ومصراً على سياسة القفز وحرق المراحل التي نتيجتها السقوط في الهاوية كما أكدتها تجارب العراق السابقة. ويا حبذا لو تفضل علينا المحرضون على العراق الجديد بتقديم البديل الأفضل والممكن عملياً عما تحقق لحد الآن؟ في الحقيقة ليس لديهم أي بديل، بل كل ما لديهم هو تدمير ما تحقق. فمن ألف باء السياسة أنه يجب أن تكون الرغبات والمطالبات واقعية وقابلة للتنفيذ، لأن السياسة فن الممكن، وليس فن تحقيق الخوارق والمعجزات، لذا من الحكمة أن نقبل بالممكن ونطالب بالمزيد.
نعم هناك نواقص كثيرة في الديمقراطية العراقية الناشئة، وأخطاء كثيرة وأحياناً خطيرة ترتكب هنا وهناك من قبل هذه الجهة المشاركة في السلطة أو تلك وما أكثرها. ولكن هذه الأخطاء والمعوقات يجب مواجهتها بهدوء وعقلانية وبذهنية متفتحة، والنقد البناء لتصحيحها، وليس بالتحريض والتخوين، فكيل اتهامات التخوين والتحريض يصب في مصلحة فلول البعث وحلفائهم من أتباع القاعدة. وفي جميع الأحوال، يجب أن لا نسمح لردود أفعالنا على الأخطاء الآنية أن تترك آثاراً تدميرية دائمة.
كما وإنني أدين بشدة أولئك المشاركين في السلطة، على محاولاتهم لأسلمة المجتمع، وتصريحاتهم الهستيرية ضد الحريات الشخصية، وقراراتهم المجحفة في غلق المنتديات الترفيهية، ومحاربتهم للفنون الجميلة وغيرها، بل وقد بلغ الجهل بالبعض منهم إلى حد أن جعل كلمة (الحرية) مرادفة (للعركجية). هذا الموقف مدان وقد أدنته في مقالين سابقين، وربما سأعود إليه ثالثة في مقال آخر.
إن نتائج الانتخابات الأخيرة قد لا تكون ملبية لطموحاتنا ورغباتنا وتطلعاتنا، ولكن هذا لا يعني أنها كانت مزيفة، وأن علينا أن نرفضها بالجملة. فالوعي السياسي الشائع لدا عامة الشعب الآن هو نتاج أربعين سنة من سياسة القهر والتجهيل والحروب والإذلال والجوع والحرمان، ولا يمكن إزالة آثارها بين يوم وليلة بمجرد إسقاط حكم البعث، وإذا أخطأ الناخبون في اختيار المرشح الأنسب، فسيتعلمون من أخطائهم، وهكذا تنمو وتنضج الديمقراطية عن طريق التجربة والخطأ.
ومما يزيد في الطين بلة، فإن فلول البعث يمتلكون خبرة وإمكانيات مالية وإعلامية هائلة في تضليل الرأي العام. ففي هذه الأيام هناك تحرك من جهات مشبوهة على عدد من الكتاب لتنظيمهم في منظمة تحمل اسماً وطنياً بشعارات براقة لخدمة العراق في الظاهر، ولكن الغاية منه نشر التشويش والبلبلة الفكرية، وتشويه سمعة رجال الحكم ما بعد البعث، مقابل مكافأة مغرية للمشاركين في هذه الحملة. ويبدو أنهم حققوا خطوات في هذا المجال، إذ نستلم عن طريق الإيميل وباستمرار مواد تحمل عناوين مثل:
(خمسون ألف دينار لكل من يتظاهر ضد الحريات، وطن المفاجئات)، (خطر الرافضة على الإسلام والمسلمين أشد من خطر اليهود والنصارى)، (مديرة مدرسة المعتصم في العطيفية توزع بمناسبة [يوم الغدير] هدايا لكل من اسمه علي أو اسمها غدير، وتستثني طالبا اسمه "علي عمر..!" بقلم: أحد أولياء الأمور، إرحموا أطفال العراق من عمائم بني فارس)، (وزير الصحة يقتل أطفال مرضى المصابين بالثلاسيميا)، ورسالة تحمل مجموعة صور يدعي مرسلها أنها حفلة زواج لابنة وزير الكهرباء المستقيل، كلفت مائة مليون دولار في فندق خمس نجوم في أمريكا!! إضافة إلى سيل من التقارير والمقالات الكاذبة عن سلوك أبناء المسؤولين.
فهل كل هذه التقارير والأخبار والمقالات صحيحة، أم أنها حملة منسقة من جهات غرضها إفشال العملية السياسية؟
وماذا عن تهمة دكتاتورية نوري المالكي؟ فهل حقاً هو حاكم فردي ونسخة من صدام حسين، كما تردد بعض الصحف ومقالات الانترنت؟ وهل بإمكان أي زعيم عراقي أن يتحول إلى ديكتاتور في الظروف الراهنة؟
إذ يسأل الصديق الدكتور رياض الأمير في مقال له بعنوان: "هل يمكن أن يكون المالكي زعيما وطنيا وليس قائدا طائفيا؟". طبعاً يتوصل إلى الاحتمال الثاني.
إن اتهام أي زعيم سياسي شيعي وحتى لو كان علمانياً، ليس بالأمر الجديد، إذ بدأ في العهد الملكي مع السياسي العراقي المعروف، المرحوم صالح جبر (الشيعي)، عندما أسس حزباً له باسم (حزب الأمة الاشتراكي) ورغم أن قيادة الحزب وقواعده لم تخلُ من أعضاء من جميع مكونات الشعب، إلا إن الراحل كامل الجادرجي شن عليه هجوماً عنيفاً، متهماً إياه بالطائفية. وهذه التهمة راحت تلاحق كل سياسي أو مفكر شيعي ما لم يشارك في اضطهاد الشيعة إذا كان في السلطة، أو يتهجم عليهم إذا كان كاتباً. (راجع عبدالكريم الأزري، مشكلة الحكم في العراق، الفصل الخاص بكامل الجادرجي والطائفية السياسية وتعيين صالح جبر رئيساً للوزراء، ص 103 وما بعدها، الرابط أدناه)
لقد اتهم القوميون العرب، عبدالكريم قاسم بأنه دكتاتور، و شيوعي، وحتى أخترع له محمد حسنين هيكل اسماً حزبياً (مطر)، وبأنه عميل لموسكو وأسماه عبدالكريملين!! (أي عميل للكرملين، مقر حكم الاتحادي السوفيتي سابقاً). هذه هي الأخلاقية العربية التي حاربوا بها العراق في عهد قاسم. وتعزف اليوم نفس النغمة وذات الاتهامات تنطلق ضد المالكي، فهو طائفي وعميل لإيران ومن "مجموعة قم" وأنه يعمل لتأسيس نظام "ولاية الفقيه" في العراق، ويستخدم الديمقراطية "قناعاً" للبقاء في السلطة.
لا أريد هنا الدفاع عن السيد نوري المالكي كما يتهمني البعض، ولكن يجب الدفاع عن الحقيقة وعن عقولنا أيضاً، وإلا سقطنا في فخ البعثيين. فعلى سبيل المثال، تتردد عبارات مثل: المالكي دكتاتوراً، وأنه يمارس حكماً فردياً، وأن حزبه (حزب الدعوة) الآن يتصرف كنسخة من حزب البعث!!
ونحن إذ نسأل: كيف يمكن لرئيس وزراء أن يكون ديكتاتوراً ومعظم وزراء حكومته من أحزاب مناوئة لحزبه؟ وهل صار حزب الدعوة هو الحزب الحاكم لمجرد أن رئيس الوزراء منه؟
الحقيقة هي أن المالكي زعيم التحالف الوطني (دولة القانون+ الإئتلاف الوطني) والذي معظم أعضائه من العلمانيين ومنه كانوا يساريين وشيوعيين سابقين، ولا يشكل حزب الدعوة في دولة القانون أكثر من 10%. لذا وبشهادة السيد برهم صالح، رئيس حكومة إقليم كردستان: أن «العراق لن يحكم من قبل شخص واحد أو جهة واحدة وإنما يجب أن تنتصر المكونات الأساسية لاعتماد مبدأ الشراكة الحقيقة في تحمل المسؤولية والنهوض بها وليس التمتع بالامتيازات وحسب»، مؤكدا على أن «هناك اتفاقا سياسيا تم عقده بين الكتل السياسية وكان نقطة الخروج من دوامة أزمة تشكيل الحكومة التي عشناها خلال الثمانية أشهر الماضية». (برهم صالح، للشرق الأوسط، 15/12/2010).
فلو كان المالكي دكتاتوراً لحاز حزبه على نسبة 99% من مقاعد البرلمان كما هي حالة الأحزاب العربية الحاكمة، ولما تأخر تشكيل الحكومة كل هذا الوقت. ولكن المشكلة أن هناك من يستسهل الكلام ويطلقه على عواهنه، ويريد أن تصدقه الناس، معتمدين على ضعف الذاكرة، لأنهم ينسون بسرعة مظالم العهد السابق، وينشغلون بمشاكل الحاضر، وهذا هو سر الترحم على الماضي الذي لو عاد لحاربوه.
والجدير بالذكر أن معظم الذين يتهجمون على المالكي ويحرضون عليه، هم ممن يدعمون قائمة "العراقية" التي يتزعمها الدكتور أياد علاوي، ومعهم الصحافة السعودية، وحجتهم أن "العراقية" كانت الكتلة التي فازت بأكبر عدد من النواب، ناسين أو متناسين، أن الانتخابات التشريعية الأخيرة لم يفز فيها أي طرف بأغلبية تتيح له تشكيل الحكومة منفردا. فالعراقية لم تحصد أكثر من 28% من مقاعد البرلمان وأصوات الناخبين، وهذا يعني أن 78% من الأعضاء هم ضدها، ولذلك كان على الدكتور أياد علاوي، وليتمكن من تشكيل الحكومة، أن يسعى لإقناع كتل برلمانية أخرى للتحالف معه، ولكنه بدلاً من ذلك، اتبع نهجه البعثي القديم، فراح يهدد ويتوعد بحرب أهلية طائفية تارة، وتصعيد الإرهاب تارة أخرى، أي كما وصفه الأستاذ حسن حاتم المذكور: أن علاوي انتهج "وسائل بعثية في زمن غير بعثي". لذلك فشلَ علاوي طيلة ثمانية أشهر في تحقيق أي تحالف مع أية كتلة، بينما نجح المالكي في ذلك. فلماذا نلوم المالكي و نحمِّله مسؤولية فشل علاوي؟؟
كذلك يرى مؤيدو الدكتور علاوي أن الديمقراطية تعني أن يكون النصر دائماً إلى جانب الكتلة السياسية التي راهنوا عليها، أي كتلة "العراقية"، ويعتبرون عدم تكليف رئيس القائمة لتشكيل الحكومة دليلاً على فشل الديمقراطية في العراق، وأن الشعب العراقي أثبت أنه غير مؤهل لممارسة الديمقراطية (كذا). وبذلك فخمسة عشر مليون ناخب عراقي الذين صوتوا يوم 7/3/2010، هم جميعاً (عدا الذين صوتوا لكتلة "العراقية")، صوتوا وفق مشيئة الحكومة الإيرانية!! أليس هذا إهانة لذكاء الشعب العراقي؟
ووفق قناعتنا الشخصية، أنه بعد سقوط الفاشية البعثية لا يمكن أن يحكم العراق نظام الحزب الواحد والفرد الواحد على الإطلاق. ونقول هذا ليس من باب التمنيات أو أفكار رغبويةwishful thinking ، بل نتيجة فهمنا للواقع العراقي وما حصل في الماضي من كوارث بسبب الحكم الديكتاتوري، فمصير الدكتاتور معروف لحكام اليوم والمستقبل. والشعب العراقي بتعدديته المفرطة، القومية والدينية والمذهبية، وبعد كل تلك المعاناة والكوارث بسبب الدكتاتورية، لا يمكن أن يحكمه نظام ديكتاتوري بعد، أو نظام إسلامي وبأي شكل كان، بل محكوم للعراق الجديد بالنظام الديمقراطي الذي لا رجعة عنه مطلقاً.
الخلاصة والاستنتاج:
لا أدعي أن حكومة ما بعد البعث هي حكومة مثالية، أو أن الديمقراطية العراقية بلغت سن الرشد، فهي مازالت ناشئة وتحتاج إلى رعاية، وهناك مختلف الشركاء في السلطة من مختلف الاتجاهات، وهؤلاء منتخَبون من قبل أبناء الشعب العراقي، وانقسامهم في السلطة هو انعكاس لانقسام الشعب وفق الاستقطاب الديني والأثني والسياسي. لذلك، وفي هذه الحالة، قد تصدر قرارات خاطئة ومجحفة، من هذه الجهة أو تلك، وهذا لا يعني نهاية العالم، وأن الديمقراطية العراقية قد فشلت، ولا أن نواجهها بالتحريض وكيل اتهامات بما أنزل الله بها من سلطان، بل علينا مواجهتها بممارسة النقد البناء بهدوء، والمطالبة بتصحيح هذه الأخطاء بالوسائل السلمية المتاحة، دون اللجوء إلى لغة التخوين والتحريض، فالمعركة من أجل الديمقراطية مازالت في أولها، والنتائج تعرف بانتهاء المعركة وليس من أولها.
لذا أود هنا أن أذكر الأخوة المتشائمين والذين يكررون على مسامعنا القول بأن الشعب العراقي لم يكن مؤهلاً بعد للديمقراطية بمقولة المفكر الهندي الكبير Amartya Kumar Sen الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 1998: "يجب ألا نسأل أنفسنا هل شعب ما مؤهلاً للديمقراطية أم لا، وإنما يجب أن نعرف أنه لا يصبح أي شعب مؤهلاً للديمقراطية إلا من خلال ممارسته لها. لذلك، فالديمقراطية هي ليست الهدف فقط، بل وهي أيضاً الوسيلة لتحقيقها"
لذلك أطمئن الأصدقاء الأعزاء من المتشائمين، والمتشائلين (على حد تعبير الطيب الذكر أميل حبيبي)، أني متفائل جداً بانتصار الديمقراطية في العراق، فالديمقراطية ليست بلا أخطاء، ولكنها تمتلك آليات تصحيح أخطائها، أي آلية التصحيح الذاتي، وأن ما يجري من صراعات وأخطاء الآن، هو عبارة عن تمارين عملية ومن ضمن آلام المخاض العسير لولادة الديمقراطية الناضجة، وإن انتصارها حتمي.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :